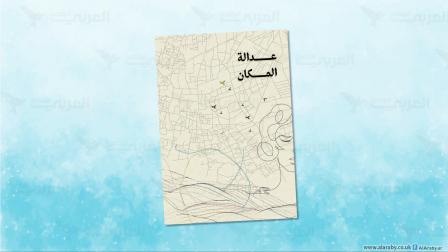"أسرار الكلمات" لتشومسكي ومورو.. حدود الذكاء الاصطناعي
كتاب عالِم اللسانيات الأميركي نعوم تشومسكي (1928)، وأستاذ اللغويات الإيطالي أندريا مورو (1962)، "أسرار الكلمات"، نقاشٌ في ما يجهل العالِمان، لا في ما هما متأكدّان منه. والجهل الذي أقصد هو قلق العالِم، واعتقاده بقصر الإنسان عن معرفة أسرار العالَم. وبدا مورو في الحوارات التي أجراها مع تشومسكي، كما لو أنَّه يبحث معه وبمعونته، عن أفق فهم الإنسان لعمل اللغة، وصولاً إلى ترجمة ذلك في الذكاء الاصطناعي.
وتأتي قراءة الحوار الذي أنجزه العالِمان عام 2021 - نُشر بالإنكليزية العام الماضي، وصدرت نسخته العربية حديثاً عن "دار فواصل" بترجمة عدي جوني - في وقتٍ تكثرُ فيه الأسئلة عن الذكاء الاصطناعي، وعن تغييره لشكل الحياة والتواصل، وعن حدود سطوه على أعمال البشر وعلى آليات تفكيرهم. وإحدى تلك الأشغال التي يتخوّف منها البشر، هي اللغة بمجالاتها المتنوّعة.
التقاءٌ مع ديكارت حول استحالة بناء آلة تُعبّر طبيعياً
تشومسكي هنا يُطمئِن البشر، لا من باب معرفتهم بـ اللغة، وإنّما من بابٍ مُفارقٍ آخَر، وهو جهلهم بها. النقاش بمعظمه يدور حول المعرفة غير المؤكَّدة للآلية التي يتعلَّم فيها الناس اللغة. ويشمل حوارُه مع مورو حتى الحقل الذي بالإمكان أن تُدرَج فيهِ مسائل اللغة، هل هو علم الأعصاب، أم السلوك أم غير ذلك. المؤكّد أنهما يبحثان في إمكانية فهم جريان الكلمات في الدماغ. وبدا تفاؤلهما تفاؤلاً حَذِراً في الحدود التي قد يصل إليها الذكاء الاصطناعي، كما شبَّه تشومسكي جوّ التفاؤل بقُدرات الذكاء الاصطناعي هذه الأيام، بتفاؤُل سادَ عند اكتشاف عِلم التحكّم الآلي والبدء بتطبيق تقنياته المُختلفة. ويقرأ تشومسكي مخاوف اليوم على ضوء تجربة أسبقَ على الذكاء الاصطناعي تعود إلى مطلع خمسينيات القرن الفائت، مع الاعتقاد الواهم بفَهم كامل تعقيدات التواصُل في الحيوان والآلة.
بدءاً من جوّ الحماسة الذي كان سائداً آنذاك، يُحلّل تشومسكي إشكالات اليوم، ويقع على ثغرات لا تزال قائمة في فهم الطريقة التي تعمل بها الكلمات، إنَّها لعبة حافلة بالأسرار. وبدا أنَّ تشومسكي يحذّر زميله مورو من الفرحة التي تسود اليوم، مُعترفاً له أنَّهما أقلّية، وفي حوارهما نَلمح سلوى الرفاق المعزولين.
مسوّغات تشومسكي للتحذير من الفرحة عديدة، منها أنَّ الأطفال الذين لم يتجاوزوا العامين يتجاهلون بنسبة مئة بالمئة ما يسمعونه، ويلتفتون لشيء "لا يسمعونه مُطلقاً". فهم يُطبّقون قواعد لغتهم الداخلية، ولا يُعيرون انتباهاً إلّا للبُنى والتراكيب التي تنشأ في عقولهم أو تُنشئها عقولهم. من غير وجود دليل واضح يُشير إلى ما يدفعهم إلى فعل ذلك. وإلى جانب الجهل بالقرائن العصبية ذات الصلة، ينقل مورو النقاش إلى زاوية أُخرى، وهي أنّه ليس في أيّ جزء من الدماغ تنشط الدارات التي تتعلّق باللغة دوناً عن الملكات الإدراكية الأُخرى، وإنّما ما المعلومات التي يُمرّرها عصبون إلى آخر؟
في جانب آخر، يُعطي تشومسكي الأولوية في تعلّم اللغات ومُمارستها للمعنى الذي من الصعب تعليمه، لا لقواعد النحو التي بالإمكان تلقينها. فالمسألة كما يراها ليست في ما نعرفه عن اللغة، وإنما في ما لا نعرفه عنها، وفي صعوبة النفاذ إلى العمليات الداخلية التي تصنع من عدّة رموز عدداً لا حصر له من الأفكار. وفي هذا، بحسب الكتاب، يلتقي مع ديكارت الذي رأى استحالة بناء آلة تنتج التعابير بالطريقة التي نقوم بها نحن بشكل طبيعي وتتناسب مع المواقف المختلفة، لا أن تكون نتائج لها. أيضاً يُقارن تشومسكي الشعور الذي يتملّك البشرية اليوم بوجود جواب عن كلّ شيء، بمرحلة سابقة من عهد البشرية في القرن السادس عشر، وكان ثمّة اعتقاد بوجود أجوبة لكلّ أنواع الأسئلة. إلا أنَّها كانت إجابات لفظية مُبهمة، يعوزها المضمون. ومن الأسئلة التي يعرضها مورو للنقاش مع تشومسكي؛ هل تستطيع الآلة أن تفكّر؟
شعورٌ يتملّك البشرية اليوم بوجود جوابٍ عن كلّ شيء
سرعان ما يعرض تشومسكي مُقاربة عن الجرذان في متاهة من الأعداد الأولية، إذ تستطيع أن تنتظر من الجرذ أن يجري في متاهة مُعقّدة، لكن ليس باستطاعتك أن تدرّبه على الانعطاف عند كلّ عدد أوّلي. إذاً، يضع تشومسكي مقاربته هذه، كي يقول ما مفاده أنّ امتلاك القدرة على القيام بأمرٍ ما، يستدعي غياب القدرة على القيام بأمر آخر. فالبشر مثلاً يعدون، لكنهم لا يستطيعون الطيران.
مقاربات غير مباشرة من هذا النوع، تُساعد المفكّر وعالم اللسانيات الشهير على تجنّب الجواب المباشر. ذلك لأنَّه يعرف العِلم، ويعرف حماقة التنبّؤ بمستقبل البحث العِلمي. لكن ما يبقى مؤكّداً في النقاش، أنَّ اللغة لغز، وتحيطها ألغاز أُخرى مرتبطة بالدماغ، وبدراسة العقل والأعصاب، وبعلاقات كلّ ذلك باللغة وإمكانية وطرائق تعلّمها. وما يُمكن أن ندعوه حذر تشومسكي ليس إلّا اعترافاً بمعجزة اخترعها الإنسان، وهي معجزة اللغة.
أندريا مورو (1962)، أستاذ اللغويات العامّة في "معهد الدراسات المتقدمة" في بافيا بإيطاليا. أسّس مركزاً لأبحاث الإدراك العصبي، وكانت تجاربه جزءاً من النقاش الذي استشهد بهِ تشومسكي في الكتاب. إذ تتركّز أبحاث مورو في العلاقة بين النحو وعلوم الأعصاب، وله العديد من الأعمال ذات الصلة، أشهرها "لُغات مستحيلة". الكورونا أجّلت حواره مع تشومسكي عدّة أشهر، قبل أن يقوما بهِ عن بُعد؛ مأخوذَين بالعلاقة بين اللغة والتكنولوجيا. وكان مورو أحد طلاب تشومسكي سنة 1988، أذكر هذا، لأنَّ في انتقالات العالِمَين بين فكرة وأُخرى من حوارهما، وكأنَّما هُما في رحلة يتشاركانها مع القارئ. رحلة البشرية من جهة، في سعيها إلى قراءة ذاتها، ورحلتهما معاً - مع ألمعية تشومسكي المؤكَّدة - في تطوير علومهما واهتماماتهما المشتركة. وما صنع غنى الكتاب، ليس فقط أفكاره وسرديته النقدية، وإنَّما ذلك السعي الودود المُتبادل بينهما، للإشارة إلى حجم ما يجهل الإنسان، وما ينتظره للقيام بتفكيكه في سبيل فهم ذاته.
(روائي من سورية)