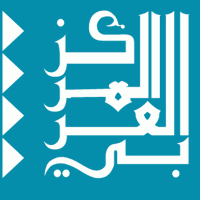هل انتهى التوافق السياسي في تونس؟
هل انتهى التوافق السياسي في تونس؟
السبسي والغنوشي في قرطاج.. هل انتهى التوافق؟ (16/7/2016/فرانس برس)
أعلن الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، انتهاء التوافق القائم مع حركة النهضة منذ تشكيل أول حكومة بعد انتخابات 2014. كما أكد موقفه الداعي إلى تغيير حكومي، ترحّل بمقتضاه حكومة يوسف الشاهد. وقد بات المشهد التونسي مفتوحًا على احتمالات عدة، وإعادة تشكّل صعبة، على الرغم من أن مواقف السبسي لم تكن مفاجئة، أخذًا في الاعتبار الأزمة السياسية المستمرة في تونس منذ أشهر.
صراع الرئاستين
لم يكن الخلاف المعلن بين قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية) والقصبة (مقر رئاسة الحكومة) وليد الأسابيع الأخيرة، بل إنه يمتد إلى كانون الثاني/ يناير 2018، حين دعا السبسي الأطراف الموقعة على وثيقة قرطاج التي تم على أساسها تشكيل حكومة الشاهد، إلى الاجتماع، مجدّدًا، للتوافق على خريطة طريق جديدة للعمل الحكومي. وهو ما عرف لاحقًا باسم "وثيقة قرطاج 2"، والتي لم توقّع بسبب الخلاف حول البند 43 الداعي إلى إجراء تغيير حكومي؛ ما يعني، ضمنيًا، رحيل حكومة الشاهد، وهو البند الجوهري في الوثيقة؛ باعتبار أن بقية البنود المتعلقة بالمحاور الاقتصادية والاجتماعية والأمنية هي تكرار لبنود "وثيقة قرطاج الأولى". وفي حين أصرّ حزب نداء تونس، والاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية)، وأطراف أخرى أقل وزنًا، على رحيل الحكومة، تمسّكت حركة النهضة بما وصفته "الاستقرار الحكومي"؛ ما دفع الرئيس السبسي إلى تعليق العمل بوثيقة قرطاج، لتدخل الأزمة السياسية طورًا جديدًا، تراجعت فيه سياسة التوافقات التي وسمت المشهد منذ "الحوار الوطني" سنة 2013، وحلّت محلها سياسةٌ جديدةٌ، عمادها موازين القوى الحزبية والبرلمانية، بعد أن صارت "النهضة" الكتلة الأكبر وزنًا بـ 68 نائبًا، في مقابل تراجع كتلة "نداء تونس" إلى المرتبة الثالثة، بفعل نزوح كثيرين من أعضائها إلى كتلة "الائتلاف الوطني" الموالية للشاهد. كما عزّزت حركة النهضة حضورها بحيازتها المرتبة الأولى في الانتخابات البلدية الأخيرة (2018)، في مقابل حلول قوائم "نداء تونس" ثالثة، بعد القوائم المستقلة.
لم يتعلق الخلاف الحاد بين رئاستي الجمهورية والحكومة، منذ خروجه إلى العلن، بتمايز الرؤى حول البرامج والخيارات الكبرى للحكومة، بقدر ما كان امتدادًا للأزمات الداخلية التي يمرّ بها حزب نداء تونس، منذ السنة الأولى التي تلت تصدّره المشهد إثر انتخابات 2014. فلم يمض وقت طويل، حتى بدأت التناقضات في الظهور بين مختلف المكونات التي اجتمعت، قبل الانتخابات، حول الرئيس السبسي، لتشكيل كيانٍ سياسيٍّ قادر على منافسة حركة النهضة، من دون إيلاء شروط التنظيم والهيكلة والمأسسة والبرامج اعتبارًا يذكر. ففي أيلول/ سبتمبر 2015، انسحب الأمين العام للحزب، محسن مرزوق، ومعه عدد كبير من الكوادر والأعضاء والنواب، ليشكّل فيما بعد حركة مشروع تونس. وفي آذار/ مارس 2016، انسحب رئيس الهيئة السياسية، رضا بلحاج، ومعه مجموعة أخرى من القياديين، ليتواصل نزيف الاستقالات والتشققات، ولتنزل معه كتلة الحزب في البرلمان من المرتبة الأولى إلى الثالثة.
علاوة على ذلك، نشب صراع نفوذ بين قيادات حزب نداء تونس ساهم في إضعافه أكثر؛ فبعد مغادرة الرئيس السبسي قيادة الحزب، إثر توليه رئاسة الجمهورية، شهدت الهياكل العليا حالة فراغ تحولت، شيئًا فشيئًا، إلى صراع خفي، ثم معلن، بين شخصياتٍ ترى نفسها مؤهلة للقيادة وملء الفراغ الذي تركه السبسي الذي ترأس الحزب منذ تأسيسه في يونيو/ حزيران 2012. كانت شخصية نجل الرئيس، حافظ قائد السبسي، رئيس الهيئة التنفيذية، حاضرة في مختلف مراحل صراع النفوذ داخل حزب نداء تونس، على الرغم من تعدد الشخصيات ومراكز القوى التي ارتبط اسمها بهذا الصراع؛ ما جعل المعركة تبدو، في عمقها، معركةً بين القيادات الطامحة إلى أداء أدوار متقدّمة، من جهة، والرئيس وأسرته الساعية إلى تثبيت نفوذها ومراكمته في المحطات السياسية المقبلة، من جهة أخرى.
حركة النهضة: مخاض التوافق وما بعده
بعد تصدر حزب نداء تونس نتائج انتخابات 2014 بفارق طفيف عن حركة النهضة، شُكّلت حكومة الحبيب الصيد، بمشاركة عدد محدود من وزراء الحركة، في حين كانت أغلبية الوزارات من نصيب حزب نداء تونس. وعدّت هذه المشاركة، حينها، في رأي مراقبين، اختراقًا في لحظة إقليمية ودولية، طغى عليها الخطاب الداعي إلى إقصاء الإسلام السياسي واستئصاله، في حين ذهب آخرون إلى أن الأمر لم يكن خيارًا، بقدر ما كان ضرورةً فرضتها الخريطة السياسية التي أنتجتها الانتخابات التي منحت كلا الطرفين حظوظًا متقاربة، يصعب في ظلها انفراد لونٍ سياسيٍّ واحد بتشكيل الحكومة، كما كانت استجابةً لمطالب فئات شعبية واسعة، ودعوات قوى خارجية إلى الحفاظ على استقرار نسبي في تونس، عبر مشاركة محسوبة للنهضة، وذلك على الرغم من الرمزية التي وسمت مشاركة "النهضة".
ظلت مشاركة حركة النهضة في الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2014 (حكومتا الصيد الأولى والثانية، وحكومتا الشاهد الأولى والمعدّلة) من دون وزنها البرلماني بكثير. ساهمت الحركة، بمشاركتها هذه، في تأجيج الصراع الدائر داخل حزب نداء تونس بين الداعين إلى الحفاظ على التوافق بين الحزبين من جهة، ورافضي أي تعايش مع الإسلام السياسي، خصوصا من العناصر العلمانوية التي تحسب لسببٍ ما على اليسار، من جهة أخرى، على الرغم من أن هذه المشاركة لم تكن السبب الرئيس والمباشر في هذا الصراع. وفي المقابل، لم يمنع التوافق خروج أصواتٍ، بين حين وآخر، معلنة تبرّمها من هذا الخيار الذي كلف حركة النهضة، في رأيها، أثمانًا سياسية وانتخابية باهظة، على الرغم من التزام قيادات الحركة ترويج خطاب التوافق. ودخل الخلاف، بين الداعين إلى الحفاظ على التوافق مع الرئيس السبسي، والداعين إلى فكّه، ودعم استقرار حكومة الشاهد، مرحلةً جديدة من خلال الرسالة التي وجهتها قيادات في "النهضة" إلى رئيس الحركة، راشد الغنوشي، ويتلخص مطلبها أساسًا في ضرورة المحافظة على الوفاق مع السبسي، وعدم التعويل على وفاق جديد مع الشاهد. وتأتي الرسالة، بعد أيام قليلة من إعلان السبسي انتهاء التوافق بينه وبين حركة النهضة ورئيسها. وتخشى هذه القوى ألاّ يكون الشاهد قادرًا على تشكيل قطبٍ علماني قوي، يمثّل بديلًا من السبسي في تحالف ديني - علماني تحتاجه "النهضة"، ويشكل سندًا قويًا للنظام في مرحلة التحول الديمقراطي. إن مجرد خروج تضارب الرؤى داخل حركة النهضة إلى العلن، في حزبٍ عرف بقدرته على احتواء خلافات قياداته داخل أطره التنظيمية، يعدّ مؤشرًا على حرج اللحظة التي وجدت الحركة نفسها في خضمها، على الرغم من أن هذا التضارب لم يرْقَ، حتى الآن، إلى مرحلة التشظّي التي يشهدها "نداء تونس".
خلاف الشاهد - السبسي
لم يُعرف عن يوسف الشاهد تجربة سياسية أو نضالية، قبل دخوله حكومة الصيد وزيرًا للتنمية المحلية سنة 2016، عدا انخراطه فترة وجيزة في الحزب الجمهوري، ثم مغادرته للالتحاق بحزب نداء تونس. ولم يكن اسم الشاهد مطروحًا للنقاش بين الأطراف التي اجتمعت ضمن ما يعرف بـ "وثيقة قرطاج"، للبحث عن بديلٍ من رئيس الحكومة السابق، الحبيب الصيد، إلى أن اقترحه الرئيس السبسي في خطوةٍ فاجأت متابعي المشهد السياسي التونسي. في هذا السياق، ذهب متابعون إلى أن ضعف تجربة الشاهد السياسية وحداثة عهده بالعمل الحكومي كانا الدافع غير المعلن وراء هذا الخيار، على الرغم من أن الرئيس السبسي لم يقدّم، حينها، مبرّرات لاختياره الشاهد رئيسًا لحكومة "الوحدة الوطنية"؛ إذ في نظرهم يسهل تحويله إلى مجرد "وزير أول" يمارس عمله تحت سلطة رئيس الجمهورية الذي منحه الدستور صلاحياتٍ أقل من رئيس الحكومة؛ الأمر الذي عبر السبسي عن تبرّمه منه في أكثر من مناسبة.
لكن سرعان ما بدأت أنباء الخلافات تتسّرب إلى وسائل الإعلام، في السنة الثانية، على الرغم من أن علاقة رأسي السلطة التنفيذية؛ السبسي والشاهد، شهدت مرونةً نسبية، خلال السنة الأولى، فلم يصبح الشاهد مجرد وزير أول في حكومة الرئيس، بل باشر بأداء دور رئيس حكومة فعلي. كان اسم الرئيس حاضرًا في مختلف فصول التنازع، على الرغم من أن الخلاف المعلن، حينها، كان بين الشاهد ونجل الرئيس حافظ السبسي، رئيس الهيئة التنفيذية لحزب نداء تونس؛ إذ يدرك متابعو المشهد السياسي التونسي أن الحديث عن طموحات حافظ السبسي غير ممكن خارج سياق سلطة والده. ومثّلت كلمة الشاهد التي وجهها إلى التونسيين في 29 أيار/ مايو 2018، وحمل فيها على نجل الرئيس، واتهمه بتدمير الحزب، مؤشرًا جليًّا على أن التشظي الذي أصاب حزب نداء تونس في تصاعد، وأن الشرخ الذي أصاب علاقة رأسي السلطة التنفيذية يصعب رتقه.
مستقبل الأزمة
رفض الرئيس السبسي اللجوء إلى الفصل 99 من الدستور الذي يمنحه حق دعوة البرلمان إلى التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها، على الرغم من أنه نصح رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بالتوجه إلى البرلمان، لتجديد الثقة في حكومته؛ وذلك لخشيته - على ما يبدو - من أن تبوء المحاولة بالفشل في ظل توقع تصويت نواب كتلة النهضة والنواب المنشقين عن كتلة النداء؛ الذين يمثلون، معًا، الأغلبية المطلقة، لصالح حكومة الشاهد. ويعني ذلك خسارة جديدة لرئيس الجمهورية أمام رئيس الحكومة. وبإعلان السبسي فكّ التوافق مع حركة النهضة ورئيسها، وفي ظل تراجع الكتلة البرلمانية لنداء تونس لصالح كتلة "الائتلاف الوطني" الموالية للشاهد، ومع تواصل نزيف الاستقالات من حزبه، يكون الرئيس التونسي في وضع يتراجع فيه رصيده السياسي، وتتقلص هوامش المناورة أمامه، على بعد سنةٍ من الانتخابات التشريعية والرئاسية، المقرّرة أواخر سنة 2019، والتي طمأن الرئيس التونسيين على إجرائها في موعدها من دون أن يفصح، حتى الآن، عن دوره فيها.
كما أنه لا يتوقع انسحاب سياسي مخضرم، مثل السبسي، بهدوء، على الرغم من التراجع الملحوظ في حضوره السياسي، مقارنة ببدايات عهدته سنة 2014. على صعيد ثان، يضيف الجدل الدائر بين قيادات حركة النهضة بشأن فكّ التوافق مع الرئيس وحزبه مؤشرًا آخر على الرغبة في الحفاظ على حدٍّ أدنى من التواصل معه، غير أن ذلك لن يعود، على الأرجح، بالأمور إلى ما كانت عليه طوال السنوات الأربع الأخيرة، خصوصا في ظل تواتر أحداث سياسية متفرقة أثبتت التجارب السابقة أن البحث عن خيط ناظم بينها، وإن كان خفيًّا، من شأنه المساعدة على فهم وجهة التحالفات. ففي 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، عقدت الجبهة الشعبية (ائتلاف أحزاب يسارية وقومية) ندوة صحافية، حاولت فيها تأجيج الاستقطاب من جديد بإعادة طرح قضية اغتيال القيادي اليساري، شكري بلعيد، متهمةً حركة النهضة، صراحةً، بتشكيل جهاز خاص، بالتعاون مع أطراف إقليمية ودولية وبالتورط المباشر في اغتيال بلعيد. وهو ما نفته "النهضة"، ودحضه الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، سفيان السليطي الذي شدّد على ضرورة الابتعاد عن توظيف القضية، والنأي بالسلطة القضائية عن كل التجاذبات.
وتأتي الحملة ضد "النهضة" بعد أيام من إعلان السبسي فكّ التوافق معها، وتعيد إلى الذاكرة ما كان يعرف بتحالف جبهة الإنقاذ الذي جمع حزب السبسي والجبهة الشعبية وأطرافًا أخرى لإسقاط حكومة الترويكا التي كانت تقودها "النهضة" سنة 2013، من دون إغفال الفوارق بين المرحلتين، وأهمها تشتت التحالف السابق وصعوبة إعادة جمع أطرافه. وفي سياقٍ غير بعيد، يظل موقف الاتحاد العام التونسي للشغل، الداعي إلى رحيل حكومة الشاهد، والذي يلتقي موضوعيًا مع جناح الرئيس السبسي والجبهة الشعبية، من عوامل الضغط الواجب أخذها في الحسبان، غير أن الشاهد يبدو قد تمكّن من استيعاب الهجوم النقابي، نسبيًّا، مستغلًا بعض الإضرابات العشوائية التي نفذتها النقابات القطاعية، أخيرا، والتي لقيت معارضة وتنديدًا واسعًا لدى الرأي العام. ويظل الإضراب العام الذي هدّد اتحاد الشغل بتنفيذه، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، ومدى قدرته على المضي في تهديده، مناسبةً لقياس موازين القوى بينه وبين حكومة الشاهد.
وفي هذا الخضم، وبالنظر إلى التوازنات السياسية والبرلمانية، وحالة النزوح الكثيف من جناح السبسي إلى جناح الشاهد في حزب نداء تونس، علاوة على ما قام به الأخير من اختراقات عديدة في مستوى الجبهة الداخلية، وتحديدًا في بعض المعاقل التقليدية للحزب ذاته على غرار منطقة الساحل (المنستير) وصفاقس والقصرين وغيرها من المناطق، فإنه يستبعد سقوط الحكومة في المدى القصير، غير أن تغييرًا جزئيًّا يظل متوقعًا على رأس بعض الوزارات، كما تظل إمكانية انسحاب الشاهد، قبل انتخابات 2019 بأشهر، بعد تأمين كتلة برلمانية وازنة وكيان حزبي مؤثّر، واردةً، وربما تكون تهيئة لخوض الانتخابات.